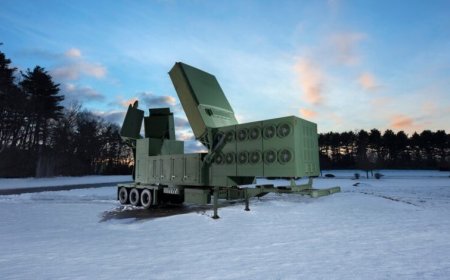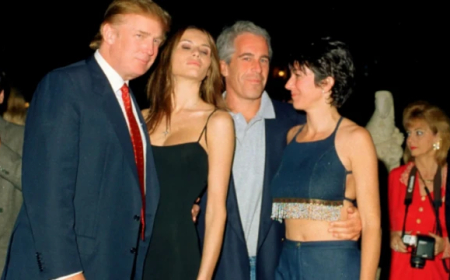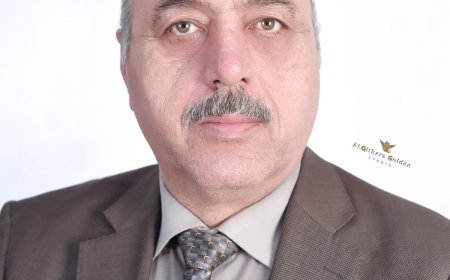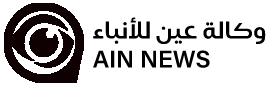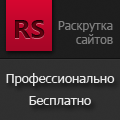سؤال التنوير..كيف يجب أن نعيش ؟
عين نيوز


ويعلم العقل الذي يكون هو القانون ، كل البشر إذا استشاروه ، إنهم لما كانوا جميعاً متساوين ، ومستقلين ، فإنه لا ينبغي أن يوقِع أحد منهم ضرراً بالآخر في حياته ، أو صحته ، أو حريته ، أو ممتلكاته .. ولما كنا مزودين بملكات متماثلة ، ونتشارك كلنا في مجتمع واحد للطبيعة ، فإنه لا يمكن افتراض أي خضوع بيننا قد يجعل لنا السلطة لأن يحطم بعضنا بعضاً ، كما لو كنا قد خلقنا من أجل مآرب الآخرين ، مثل الحيوانات الدنيا التي خلقت من أجلنا "
جون لوك
| الحلقة 11 |
علــي حســـين
خلّف سقراط لتلامذته ثلاث مهام ، وهي : تعيين مضمون نافع عقلياً على نحو أدق ، وإعطاء العالم الفكر الأكبر عن قيمة الأخلاق ، والتفكير بالعدالة بوصفها داخلة في نطاق نظرة كونية .
فما هي النتائج التي وصل إليها أولئك الذين اهتموا بمسألة العدالة وحاولوا أن يحددوا ما هو نافع عقلياً استنادا الى تجربة الديمقراطية التي عاشتها أثينا في ذلك الوقت ..قبل وفاة سقراط بثلاثة أعوام قام تلميذه أفلاطون بمحاولتين لدخول السياسة ، الأولى في هزيمة أثينا أمام إسبرطة في الحرب التي اطلق عليها اسم " البيلوبونيسية " ، والثانية بعد عام ، عندما استعادت أثينا نظامها الديمقراطي ، لكن المحاولتين فشلتا مما جعل هذه التجربة خيبة أمل لأفلاطون بالحياة السياسية ، حيث أدرك أن التغيير لا يمكن أن يأتي إلا من خلال حكم جديد تماماً .وكان كتاب " الجمهورية " هو الأساس لتنوع الدولة المثالية التي حلم بها ، وقدّم سقراط من أجلها حياته .
أذن كانت السياسة الباعث الأساس الذي دفع أفلاطون الى البحث الفلسفي في مفاهيم مثل الحكم والعدالة والقانون ، وإن الحكم الذي صدر على أستاذه جعله يبحث عن العلّة في فساد الدول ، والسبيل الى إصلاح أنظمة الحكم .
ولد أفلاطون عام 427 قبل الميلاد لأسرة غنية أتاحت لإبنها أن يتعلم البلاغة والموسيقى و الرياضيات وأن يؤلف الشعر وهو صغيراً ، ويكتب المسرحيات متاثراً بالمسرحي الشهير آنذاك " يوربيدس " ، وظلت عائلته تهيئه لدخول العمل السياسي إسوة بأجداده الذين مارسوا الحكم في أثينا ، لكن حدث أن التقى الشاب أفلاطون برجل يلقي الخطب والمواعظ في الأسواق اسمه سقراط فأصبح لايفارقه مثل ظله ، ويقال إن أفلاطون الذي كان اسمه " ارستوكليس ابن أريستون" سماه سقراط بأفلاطون لامتلاء جسمه وقوة بنيانه .
، ولم يكن اللقاء بسقراط أول معرفة أفلاطون بالفلسفة ، فقد سبق له أن تعرف على السفسطائيين الذين كانوا كانوا يرفعون شعار لاحقيقة مطلقة أبداً ، وكانوا يعيبون على الفلسفة إنها تبحث عن الحقيقة المطلقة التي لاوجود لها في الطبيعة حسب قولهم ، ولهذا ركزوا على البحث في الإنسان باعتباره كائناً اجتماعياً ، وكانوا يمتدحون سقراط لأنه حسب قولهم أنزل الفلسفة من السماء واسكنها المدن وأدخلها البيوت وجعلها ضرورية لكل بحث في الحياة والأخلاق والخير والشر . وقد تركت هذه الأفكار في نفسه أثراً قوياً ، ولكنه في الوقت الذي أخذت عائلته تطالبه بأن يعمل في مهنة أجداده ، جاء سقراط ساخراً ليقول له :"المعرفة أولاً" . لقد كان هذا هو الدرس الأول الذي تعلّمه أفلاطون من سقراط ، فقلب حياته ، وجعله يعيد التفكير في كل ما تعلّم من قبل . فبمجرد أن انتهى من حواره مع سقراط حتى ذهب الى البيت ليحرق كل قصائده ، ويمزق كل ما كتبه من قبل ، وينسى هيامه بالمسرح ، وكل ما يتعلق بعشقه للرياضة ، وتبع سقراط الذي بدا وكأنه مارس عليه السحر ،على حد تعبير ديورانت في "قصة الفلسفة : " وقد رفض كل محاولات عائلته للحصول على وظيفة كبيرة في الدولة، فقد فضّل أن يبدأ بالمعرفة أولاً . كان سقراط يحاول أن يوضح لأفلاطون مفاهيم العدالة والأخلاق ، وكيف يكون الإنسان إنساناً ، وكيف يمكن له أن يعيش تحت حكم العقل حياة إنسانية متميزة ، :"إن أعظم خير للإنسان هو أن يكون حديثه كل يوم عن الفضيلة والأخلاق والعدالة ، فالحياة غير المحصّنة بهذه القيم ليست حياة "
لم تدم رفقة افلاطون لسقراط طويلاً، فبعد ثماني سنوات من تاريخ أول لقاء ، يتم إلقاء القبض على سقراط وتقديمه للمحاكمة التي تأمر بإعدامه ، كان أفلاطون حينها في الثامنة والعشرين من عمره ، لقد تحطمت آماله في الحياة العامة في أثينا ولهذا نجده يكتب :" أدركت أخيراً إن أنظمة الحكم في كل البلدان من دون استثناء سيئة ، ولذلك فأنا مجبر على القول إن الجنس البشري لن يعيش أياماً أفضل إلى ان يتولى السلطة السياسية من يتبعون الفلسفة حقاً وصدقاً ، أو حين تحيل العنائية الإلهية من بيدهم السلطة السياسية إلى فلاسفة حقيقيين .
بعد موت سقراط يرحل أفلاطون عن أثينا ، وتطول أسفاره ، لكنه في النهاية يعود الى مدينته ليشتري قطعة كبيرة من الأرض ، ينشأ عليها أكاديميته الشهيرة ، والتي ظل يُعلِّم فيها طوال أربعين عاماً . وقد اختار لها مكاناً كان سقراط يعلم فيه تلامذته من الشباب ، وسميت الأكاديمية لأنها أقيمت على بستان كان ملكاً للبطل اليوناني " اكاديموس " ، وقد اشترى أفلاطون قطعة الأرض وسط هذا البستان ، وكان تلامذته من الشباب الذين هيّأهم لكي يمارسوا العمل السياسي والفكري . ولم يُعرف عن أفلاطون إنه كان يتقاضى أجراً على التعليم ، واعتمدت الاكاديمية على هبات الأغنياء ، وعلى إعانات اختيارية من أولياء أمور بعض الطلبة الأغنياء .. وكانت الأكاديمية أشبه بجماعة دينية ، يعيش أعضاؤها عيشةً مشتركةً ، ومنهم بالطبع أفلاطون صاحب المدرسة ، وكانت رئاسة المدرسة تنتقل من شخص الى آخر عن طريق الانتخاب السري ، ومن خلال المدرسة استطاع أفلاطون أن يطبق نظريته عن الفيلسوف الذي يصبح ملكاً أو الملك الذي يصبح فيلسوفاً ، والتي شرحها لنا في كتابه الشهير "الجمهورية" وفيه يعرض برنامج عمل للحكومة المثالية لمجتمع مثالي .
ظل أفلاطون يحفظ درس أستاذه سقراط من أن الفضيلة هي المعرفة ، وإن الفضيلة يمكن تعلمها .وبالحديث مع الناس وجعلهم يفكرون ، نحثهم ليصيروا فاضلين ، وعندئذ سيسلكون طريق العمل الصحيح ، ويتبع ذلك إنهم سيعيشون سعداء ، ويكمل افلاطون نظرية أستاذه سقراط بالقول إن المعرفة الحقة هي المعرفة بمثال الخير .
لأن الفلاسفة يتقنون التفكير حول الواقع، يعتقد أفلاطون بأنه يجب عليهم أن يتحملوا المسؤولية و تكون لهم السلطة السياسية. في مؤلف الجمهورية، يصف أفلاطون مجتمعاً مثالياً خيالياً. يكون فيه الفلاسفة في أعلى سلطة في المجتمع و يكون لهم تعليم خاص، غير إنه يجب عليهم أن يتخلوا عن لذاتهم الخاصة من أجل المواطنين الذين يحكمونهم. يوجد تحتهم الجنود الذين يُدَربون للدفاع عن البلد، و تحتهم يوجد العمال. ستكون هذه المجموعات من الناس في توازن مثالي، توازن يشبه حسب أفلاطون العقل المتزن الذي يتحكم جانبه العقلاني في المشاعر و الرغبات.
*****
العدالة صفة فرد ، ولكنها كذلك صفة المدينة كلها
سقراط
يدور الحديث في كتاب " الجمهورية " لأفلاطون بإسلوب روائي ، البطل فيه سقراط الذي يُلقي على سامعيه اسئلته عن الحقيقة .
وفي الجمهورية يبدأ سقراط في السؤال عن ما هي العدالة ؟ فيقول بوليمارخوس إنها تقتضي بأن يرد الإنسان كل ماله ، وإنها معاملة كل حسب ما يستحق ، ويرفض سقراط هذا التعريف ، إذ كيف يضر العادل أعداءه وبمعنى آخر كيف يقترف العادل ظلماً من خلال عدالته ، ويعترض تراسيماخوس الذي يقدم تعريفاً ثانياً للعدالة يؤكد فيه : إن العدالة ليست سوى العمل بمقتضى مصلحة الأقوى . وفي مقابل هذه الآراء نجد سقراط يلجأ الى تشبيه الحكم بأنه فن من الفنون المفيدة للإنسان ، غايته تحقيق فائدة للغير لا لأصحابه ، ولهذا فإن الحاكم ضمن مفهوم أفلاطون هو من يعمل لا لمصلحته الشخصية ، بل لمصلحة رعيته ، ثم يحاول سقراط أن يقدم وصفاً للعدالة ، فيقول إن لكل شيء وظيفة خاصة به ، فكما أن للعين وظيفة لاتشاركها فيها الأذن وفضيلتها في أدائها لهذه الوظيفة ، كذلك تكون للنفس وظيفة هي الحياة وفضيلتها في حسن توجهها للحياة لتبلغ السعادة ، وما العدالة إلا فضيلتها التي هي وسيلتها للسعادة .
ولعل السؤال الأول الذي يُثار في محاورة الجمهورية هو : ما هي قاعدة الخير التي يتعيّن على الإنسان أن ينظم حياته وفقاً لها ؟ . وهنا يثير أحد التلاميذ مفهوم العدالة عند الناس ، فيقول إن الناس لاترغب في العدالة لذاتها ، وإنهم لايلتزمون بها إلا مجبرين حتى لايصيبهم أذى من غيرهم إن عرفوا بالظلم .
ونجد سقراط يرد بهدوء لكي يثبت أن العدالة قيمتها في ذاتها ، وإنها الخير الوحيد للنفس الإنسانية ، وبها وحدها يدرك الإنسان السعادة .
سقراط : لتعلم إذن منذ البداية وعندما شرعنا في تأسيس مدينتنا ، أخذنا على عاتقنا واجباً هو أن نبيّن ما هي العدالة ، ولقد ذكرنا مراراً إن كنت تذكر إنه لاينبغي لأحد أن يمارس إلا عملاً واحداً في المجتمع وهو العمل الذي هيأته له الطبيعة.
- أجل قلنا ذلك
سقراط : وقلنا إن العدالة تتلخص في انصراف كل إلى عمله وبدون أن يتدخل في أعمال الغير ، أي إن العدالة هي في اهتمام الكل بما يخصه .
هكذا يبين أفلاطون إن خير الأمم ، هي تلك التي تقدر التخصص وسيؤدي كل المواطنين العمل الذي يتمتعون بالأهلية الطبيعية له ، بغض النظر عن المولد والنسب ، ويمكن للمرأة أن تصل إلى أعلى المراتب بسهولة . لم يكن أفلاطون مناصراً للمرأة بالمعايير الحديثة ، لكنه يقول في الجمهورية إن المرأة يجب أن تحصل على الفرص نفسها التي يحصل عليها الرجل ، وإن أية امرأة أثبتت كفاءتها يجب أن يسمح لها بالترقي في مراتب المجتمع .
وإذا تساءلنا عن الأسباب التي دعت أفلاطون الى تقديم هذا التعريف للعدالة والمساواة ، فإن الإجابة سنجدها في الفصل الذي خصص لمفهوم الدولة والمجتمع ، فالدولة تنشأ في رأي أفلاطون من "عجز الفرد عن الاكتفاء بذاته وحاجته الى أشياء لاحصر لها "، ولما كانت حاجات الفرد عديدة لايستطيع القيام بها لوحده ، فهو إذن في حاجة الى مساعدة المجتمع . وهنا يبين لنا أفلاطون ضرورة الاجتماع البشري كأصل لنشأة الدولة ، فالدولة لاتنشأ إلا لتلبية الحاجات المعنوية والمادية التي لايستطيع الإنسان أن يلبيها بمفرده .
إن الدولة المثالية عند أفلاطون هي التي تقوم على مبدأ تقسيم العمل بين أفرادها الذين يضعهم أفلاطون في جمهوريته في ثلاث طبقات أساسية هي: طبقة المنتجين وطبقة الجنود وطبقة الحكام ، وكل طبقة من هذه الطبقات ينبغي أن تؤدي وظيفتها على الوجه الأكمل متحلّية بفضائلها وبدون أن تتدخل أية طبقة في عمل الأخرى ، ويشترط في طبقة الحكام أن تكون من الفلاسفة :"ما لم يتولَّ الفلاسفة الحكم في الدول ، أو أن يتحول من نسميهم ملوكاً وحكاماً إلى فلاسفة حقيقيين ، وما لم نر القوة السياسية تتحد بالفلسفة ، وما لم تسن قوانين دقيقة تبعد من لم يجمعوا هاتين القوتين ، فلن تنتهي الشرور من الدول".
يجعل ديف روبنسوف في كتابه "فلسفة أفلاطون" من فكرة التربية محوراً لتفسير فلسفة أفلاطون ، فكل الأبحاث التي تضمنتها محاورة الجمهورية وضمنها مناقشة الأنواع المختلفة للدساتير ، وأسباب انحلال الأنظمة السياسية ، تستهدف في آخر الأمر غاية تربوية . ويوضح روبنسون وجهة نظره بالقول : " قد نظن لأول وهلة إن أفلاطون كان يهتم بتأسيس دولة مثلى ،تحكمها صفوة مختارة ، وكان يخضع الأخلاق والتربية لهذه الغاية ، ولكننا عندما ندرس الجمهورية يظهر لنا بوضوح كامل ما كان يرمي إليه أفلاطون ، فهو يبني السياسة على الأخلاق ، لأنه يؤمن بأن ، مبدأ السلوك الذي يرشد المجتمع والدولة هو نفسه الذي يرشد الفرد في سلوكه الأخلاقي " .
********
نصبح شيئاً ما عبر قيامنا بالأفعال التي تتصف بهذا الشيء ، نصبح معتدلين عبر قيامنا بأفعال تتصف بالاعتدال ، وشجعانا بقيامنا بأفعال تتصف بالشجاعة
أرسطو
على مدار قرون ، حاول الكثير من الأفراد والمجموعات البشرية تطبيق رؤاهم على أرض الواقع ، حاول البعض أن يحقق ذلك من خلال السلطة ، وحاول آخرون من خلال الفكر والحكايات الاجتماعية ، حتى أن ماركس كتب ذات يوم الى انجلز :" أعود بين الحين والآخر الى كتاب الجمهورية ، الحلم الذي أراد أن يحققه أفلاطون ، مجتمع عادل في دولة يسودها العدل والمساواة.. " ، هذا المجتمع الذي وصفه بعد وفاة أفلاطون بأكثر من 1200 عام فيلسوف مسلم ولد في عام 870 في مدينة فارب الواقعة بإقليم خراسان ، وقد روى لنا ابن ابي أصيبعه في موسوعته " عيون الأنباء في طبقات الأطباء " إن والده كان فارسي الأصل تزوج من امرأة تركية ، وأصبح قائداً في الجيش التركي ، وإن الفارابي في بداية حياته قبل ان يدرس الفلسفة اشتغل بالقضاء ، ودرس الطب في بداية شبابه ، لكنه ترك مدينته فارب بعد وفاة أمه وأبيه كان يبلغ الثامنة والثلاثين من عمره ، حيث قصد بغداد ليستقر بها ، وفي صباه كانت له مقدرة كبيرة على الدرس والحفظ حتى أن ابن خلكان يخبرنا في كتابه " وفيات الأعيان " إن ابو نصر محمد بن محمد بن طرخان المعروف بالفارابي كان يتباهى بأنه يجيد أكثر من عشر لغات أشهرها العربية والتركية والفارسية ، وفي بغداد حضر دروس بشر بن متي الذي اشتهر بتدريس المنطق في عصره ، وترجمته الى العربية عدداً كبيراً من كتب أرسطو وبعض محاورات أفلاطون وتقديم شروح لها ، عند بشر تعرف الفارابي على الفلسفة اليونانية وكان مغرما بأرسطو حتى إنه قال لبعض تلامذته إنه قرأ كتاب السياسة لأرسطو أكثر من خمسين مرة ، وحفظ محاورة الجمهورية لأفلاطون عن ظهر قلب ، وإنه في كل صباح كان يقرأ منها صفحات ، وعندما سئل عما إذا كان هو أم أفلاطون أرسخ علماً في الفلسفة قال : لو أدركته لكنت أكبر تلاميذه " ..وفي بغداد تفرغ لدراسة الفلسفة لمدة ثلاثين عاماً أصدر فيها العديد من المؤلفات كان واحداً منها كتابه الشهير " في المدينة الفاضلة " والذي سار فيه على خطى أفلاطون ، محاولاً بناء عالم مشابه لما جاء به أفلاطون في " الجمهورية ، : " إنما البشر، على تنافرهم، محتاجون الى الاجتماع والتعاون" . أي أن الإنسان، وفق مفهوم الفارابي : " لا يستطيع أن يبقى وأن يبلغ أفضل كمالاته إلا في المجتمع. وهو يصف لنا مدينته الفاضلة بأنها : " شبيهة بالجسم الكامل التام، الذي تتعاون أعضاؤه لتحقيق الحياة والمحافظة عليها" ، وكما أن :"مختلف أجزاء الجسم الواحد مرتّبة بعضها لبعض، وتخضع لرئيس واحد، هو القلب، كذلك يجب أن تكون الحال في المدينة" . وكما أن "القلب هو أول ما يتكوّن في الجسم، ومن ثم تتكوّن بقية الأعضاء فيديرها القلب، كذلك رئيس المدينة" . والرئيس هو إنسان تحققت فيه الإنسانية على أكملها. وهي الفكرة المستعاره بحذافيرها من أفلاطون، وقد سعى الفارابي الى توجيه الفلسفة وجهة سياسية واجتماعية ، فهدف الفيلسوف في المجتمع أن يكون هادياً ومُهدياً للناس " يهديه العقل بنوره ، فيُهدي هو الناس على ضوء ذلك النور نفسه " .وقد كتب الفارابي العديد من المؤلفات التي شرح فيها وجهة نظره بالسياسة وأنظمة الحكم وعلاقة المجتمع بالحاكم ، وعلاقة الحاكم بالشعب ، وأشهر كتبه في هذا المجال " كتاب تحصيل السعادة " و" رسالة في التنبيه على سبيل السعادة " وجوامع كتاب النواميس لأفلاطون " و" كتاب المبادئ الأساسية "و الملة الفاضلة " و" رسالة في آراء أهل المدينة الفاضلة " و " كلام أبي نصر الفارابي في وصايا يعم نفعها جميع من يستعملها من طبقات الناس " ..وهكذا نرى أن الآراء السياسية كانت تشغل الفارابي كثيراً ، وإنه لم يدع مناسبة إلا وعالج فيها السياسة بمختلف نواحيها .. ولعل الغاية التي سعى إليها الفارابي ليست العمل في السياسة وإنما الارشاد الى سبل تحصيل السعادة من خلال إقامة مجتمع عادل ، وإن هذا المجتمع لايقوم على جهود أفراد معينين فقط :" فليس ممكن أن يبلغها الإنسان وحده بانفراده ، دون معاونة أناس كثيرين له ، وإن فطرة كل إنسان أن يكون مرتبطا بغيره " ..ويضع لنا الفارابي تعريفاً لنظام الحكم بأنه نظام الحكم الذي يتضافر فيه الناس معاً ، ويتعاونون ، بهدف أن يصبحوا فضلاء ، ويقوموا بأنشطة نبيلة ، ويبلغوا السعادة .ويصر الفارابي على أن الحكمة أو الفلسفة شرط لايمكن الاستغناء عنه لتأسيس المدينة الفاضلة وبقائها ، وعندما يحصي الفارابي صفات الحاكم الأمثل ، أو مؤسس المدينة الفاضلة ، أن يمتلك الملكة العاقلة الممتازة ، وأن يفهم معنى السعادة البشرية ، والكمال ، ولهذا يؤمن الفارابي إنه ليس كل عضو من أعضاء المدينة الفاضلة يصلح لأن يكون رئيساً :" ورئيس المدينة الفاضلة ليس يمكن أن يكون أي أنسان ، وإنما يكون ذلك في أهل الطبائع العظيمة الفائقة " ورئيس المدينة الفاضلة يجب أن تجتمع فيه اثنتا عشرة ميزة : أن يكون تام الأعضاء ، أن يكون جيد الفهم والتصور ، جيد الحفظ لما يفهمه أو يدركه ، جيد الفطنة ذكياً ، حسن العبارة ، محباً للتعليم ، غير شرهٍ في المأكول والمشروب ، محباً للصدق وأهله ، مبغضاً للكذب وأهله ، كبير النفس محباً للكرامة ، أن يكون الدرهم والدينار وسائر الدنيا هينةً عنده ، أن يكون محباً للعدل وأهله ، مبغضاً للجور والظلم وأهلهما ، أن يكون عادلاً غير صعب القيادة ولاجموحاً ولا لجوجاً ، قوي العزيمة جسوراً غير خائف ولا ضعيف النفس " . ويؤمن الفارابي إن اجتماع هذه الخصال جميعها في إنسان واحد أمر صعب المنال ، وإذا خلت المدينة من رجل بهذه الصفات ، وكانت موزعة بين عدد من الأشخاص ، وكان اولئك الأشخاص متلائمين ، كانوا هم الرؤساء الأفاضل .إلا إنه إذا اجتمعت الصفات كلها في عدة أشخاص ما عدا الحكمة ، فان المدينة الفاضلة تبقى " بلا ملك أو رئيس ، فان لم يتفق أن يوجد حكيم تضاف إليه لم تلبث المدينة بعد مدة أن تهلك " ..يكتب إميل برهييه :" كما أصلح الفلكيون العرب أخطاء بطليموس وغيره ، كذلك حسنوا ما خلفه لهم معلموهم الإغريق من تراث سياسي ، فكتاب الفارابي آراء أهل المدينة الفاضلة يضاهي في الواقع إن لم يتفوق على ما جاء من المصادر السياسية عند أفلاطون وأرسطو " .
********
في صبيحة يوم السادس من تموز عام 1535 نُفِذ حكم الاعدام برجل كان أقرب الناس الى الملك هنري الثامن ، حين عمل بمنصب الوزير الأول ، لكنه فجاة يقدم استقالته بعد أن رفض أن يقسم إن الملك هو الرئيس الأعلى للكنيسة ، لأن ذلك يتعارض مع قيام نظام عادل وحكيم ، فيساق الى السجن ويحاكم بتهمة الخيانة ، ليقطع رأسه في النهاية ، أحب توماس مور المولود في السابع من شباط عام 1477 أموراً ستظل تشغل البشرية ، وهي العدل والمساواة ، ونادى بالعلم والمساواة وطالب بالقضاء على أسباب الظلم والحروب .وقد صاغ مور عام 1516 كلمة " يوتيبيا " في كتاب صغير تخيل فيه وجود المدينة الفاضلة أو جمهورية أفلاطون في جزيرة متخيلة ، تأسس عليها مجتمع قائم على مساواة واسعة النطاق ، يحكمه رجال حكماء ، له قوانين صارمة ، لكنه يوفرالحياة الكريمة لمعظم مواطنيه ، ويذهب مؤرخو حياة توماس مور ، أن الرجل كان متاثراً بفلسفة أفلاطون وقدم ترجمة من اللاتينية لجمهورية أفلاطون أهداها للملك هنري الثامن . في "يوتوبيا مور " ، كما هو الحال في "جمهورية أفلاطون" ، ليست ثمة ملكية خاصة، هناك الخير العام والمساواة. ، وقد حلم كاتبها بأن يعيش مواطنيه الإنكليز حياة أفضل وبنظام سياسي مثالي ، وهو الأمر الذي أدى به الى أن يُقطع رأسه ..وتأتي أهمية " يوتبيا " توماس مور بأنها أصبحت مصدر وحي وإلهام لكثير من المفكرين والمصلحين والأدباء على اختلاف فلسفاتهم ، لكن آراءهم اتفقت على ضرورة قيام عقد اجتماعي بين الشعب والحاكم ، وكان من هؤلاء جون لوك ، وجان جاك روسو ، ودايفيد هيوم .
ما هو رد فعلك؟
 أعجبني
0
أعجبني
0
 لم يعجبني
0
لم يعجبني
0
 أحببته
0
أحببته
0
 مضحك
0
مضحك
0
 غاضب
0
غاضب
0
 حزين
0
حزين
0
 رائع
0
رائع
0
 9Hits - Traffic Exchange
CAowitHADA
9Hits - Traffic Exchange
CAowitHADA